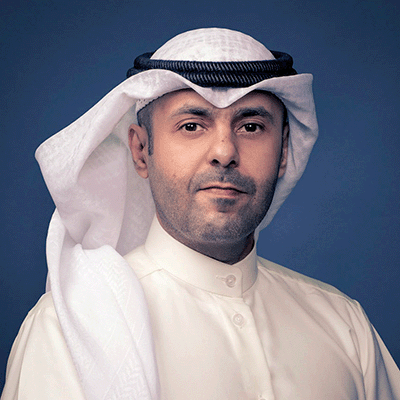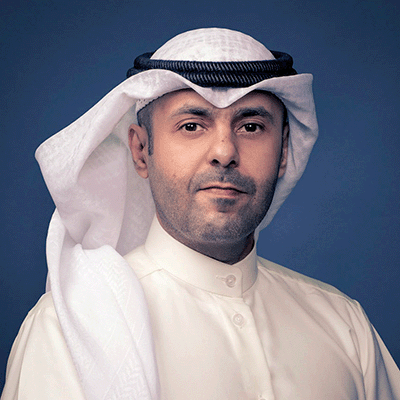نشرت في
2025/08/22 و تم طلب نسخة الطباعة في
2025/12/05
نشر في
[القبس]
لطالما درجت الألسن وتواطأت العقول على أن الرفاه لا يقاس إلا بوفرة النقد وتكاثر الدنانير، وأن السعادة رهن بما يُحمل في الكف من ذهب أو فضة، فإذا ارتفع الأجر قيل: أقبلت النعمة، وإذا قلّ قيل: أدبرت. غير أنّ هذا التصور ليس إلا وهماً تُخادع به النفوس، وظلاً يخاتل العيون، إذ إن حقيقة الرفاه أوسع من كيسٍ ممتلئ، وأبعد غوراً من رقم يُسطَّر في دفتر الرواتب، بل هو بناء متشابك الأركان، تتداخل فيه قوة العملة، ورزانة السوق، وعدالة التوزيع، ورسوخ الثقافة، وتدبير الدولة بما يحفظ ميزانها ويقيم سلطانها.
ما يحكم تذبذب الرفاه
إن الدينار لا يزن في الميزان إلا بقدر ما يُكسب صاحبه من قدرة على صون أهله وإكرام ضيفه والقيام بحاجاته. فما نفع دينارٍ مضاعف، إن كان لا يشتري إلا كسرة خبزٍ يابسة أو سقفاً من قشّ؟ وما فضل أجرٍ يسير، إن كان يُكفي صاحبه مأوى رحباً، ومائدة عامرة، وثوباً كريماً؟ فالعبرة ليست بكثرة العدد، بل بوفرة الجدوى، ولا بالمقدار، بل بما يغدو به النقد من قيمة. ذلك أن الرقم والقيمة قد يلتقيان، وقد يتفرقان تفرّق المشرق والمغرب، «فكم من قليلٍ أغنى عن كثير، وكم من كثيرٍ لم يُغن عن قليل».
وإذا التبست على الناس الحدود بين الرقم والقيمة، التبست عليهم كذلك الفوارق بين التضخم وارتفاع الأسعار؛ إذ يظنّون أن كثرة النقد في اليدين تُضاعف الغنى، وما هي إلا كثرةٌ توقد نار الغلاء وتُذيب ما في الجيب. فالتضخم وليد وفرةٍ عمياء تُغرق الأسواق بالسيولة، ومع أن الله تعالى أنذر بقوله: «إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ» (الإسراء: 27)، ففي السيولة تشتعل الرغبات وتكثر الأيادي الممدودة إلى السلع، فيتخذ التاجر من طمعه مركباً، ومن جشعه دليلاً، فيرفع الأسعار لا لنقصٍ في السلعة، وإنما لزيادة في الطلب، فإذا بالراتب المتضخّم لا يزيد صاحبه إلا عناءً، إذ يطارد السراب ولا يدرك ماءً، وكأنما هو راكب بحرٍ هائج، كلما جذف بجهده، دفعته الأمواج إلى الخلف.
وهنا، حيث يضيع المرء بين وفرة الأرقام وضيق الجدوى، يتأكد أن السعر ليس هو القيمة؛ فالسعر ما ينطق به لسان البائع، أما القيمة فهي شهادة السوق وعدل المبادلة. قد يرفع التاجر صوته بثمانية دنانير لسلعة لا تساوي إلا أربعة، فإن وُجد من يشتريها، لم يكن ذلك برهاناً على حقيقتها، بل على فساد في التقدير أو خلل في البديل. وما أشد خطورة أن تُحتكر الأسواق وتُعطل المنافسة، إذ عندها ينهار الجدار الفاصل بين السعر والوهم، وتغدو الأرقام خداعاً لا يُبنى عليه عيش كريم، كما قال العرب: «من ضاق عليه العدل، وُسِّع عليه الجور». ولذا كانت القيمة أصدق من الرقم، وأبقى من لسان البائع.
وعند هذا الحد ينكشف جوهر الحقيقة: إن رفاه المرء لا يحاكم بما يكتبه الديوان في خانة راتبه، بل بما يضعه القدر من موقع له بين متوسط دخول قومه. فإذا علا أجر قطاع بعينه دون سائر القطاعات، ارتفعت مقدرة أبنائه نسبياً، بينما بقي غيرهم على حالهم، بل قد يزداد عبؤهم إذا انعكس طلب ذلك القطاع على الأسعار. أمّا إذا ارتفعت الأجور جميعها أو انخفضت جميعها، تحركت الأسعار معها، فظل التوازن محفوظاً في صورته النسبية، وإن لم تخلُ الساحة من رياح تضخم أو سُحب انكماش. وهكذا يتبين أن العدل في الأجور ليس في كثرة العدد، بل في نسبيتها إلى المتوسط، وفي قرب المرء أو بُعده عن مركز الميزان.
معادلة الرفاه.. رياضياً
الرفاه ليس خيالاً هائماً في فضاءٍ سابح، بل هو حقيقة يمكن ردّها إلى معادلة تُقاس وتُوزن بميزان دقيق. فتأمّل شريحة من المجتمع جعلت أول همّها امتلاك المسكن، وثانية راتباً يكفي مؤونتها. فإن كانت ستة أعشارها قد ظفرت بالمساكن، وسبعة أعشارها قد كفاها دخلها، كان نصيب رفاهها قريباً من ثلثي الكمال. وهنا يتضح أن رفع المؤشر لا يكون بزيادة النقد وحدها، بل بفتح أبواب التملّك، وتيسير الحاجات، وتبسيط الوصول إليها. فالرفاه ليس فيما يُلقى في الجيب من نقد، بل فيما تنال به اليد من مقومات العيش. قال تعالى: «وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا» (القصص: 77). فالعيش الكريم مقصد معتبر، لا غاية النقد في ذاته.
وإذا بان أن الحاجات المادية تُقاس بهذه الطريقة، فإن كثيراً من الاحتياجات في حقيقتها ليست مادياتٍ محضة، بل تُثقلها الثقافة وتُوشيها المعايير الاجتماعية. فانظر إلى التعليم مثلاً: إذا ضعف التعليم العام، هرعت الأسر إلى المدارس الخاصة، حتى غدا التعليم الخاص علَماً على الجودة، وإن لم يكن دائماً كذلك. وهكذا ترفع الثقافة سقف الرفاه اصطناعاً، وتلقي على كواهل الطبقة المتوسطة حملاً فوق وسعها. فإذا أصلحت الدولة التعليم العام وأعلت من شأنه، تبدّل المعيار، وخفّ العبء، وارتفع المؤشر من تلقاء نفسه، دون حاجة إلى ديون مثقلة أو رواتب مضاعفة. غير أنّ السياسات مهما بلغت من إحكام، لن تؤتي ثمارها ما لم يعضدها وعيُ المواطن ورشدُ سلوكه الاستهلاكي، إذ هما الجناح الثاني الذي يحلّق به مشروع الرفاه.
وإذا كانت معادلة الرفاه قد أبانت أن المؤشر لا يسمو إلا بعلو نسب التملك للحاجات، فإن الأدوات الضريبية ـ إذا سُنّت بميزان الحكمة وعدل السياسة ـ تُصبح من أمضى الوسائل لبلوغ تلك الغاية. فالضريبة، في جوهرها، ليست سيفاً يقطع أرزاق العباد، بل ميزان يقيم القسط في الأرض، ويكبح من انحراف إن جار السوق أو بغى، ويكبح جماح الاحتكار، ويعيد صياغة المعادلة على نحوٍ يُقرِّب الحاجات من أيدي الناس. قال العرب: «المال خادمٌ صالح، ولكنه سيدٌ فاسد»، فالأدوات المالية، كالضريبة، ينبغي أن تُسخَّر لتكون جسر عدلٍ، يردّ على المجتمع منفعته مضاعفة، إذ يحفظ للجهد ثمرته، ويمنع أن يتساقط العرق هدراً بين هوة التضخم أو فوضى الطمع. وما الغاية من هذه الأدوات حين تُطبّق إلا أن ترتفع نسب تملك الاحتياجات ارتفاعاً مباشراً، فتغدو الحياة أوفر عدلاً، ويزداد مؤشر الرفاه ثباتاً وسمواً، وتستقيم موازين المجتمع على اعتدال.
إستراتيجية رفاه
من هنا يلوح المقترح باستراتيجية «رفاه». ليس شعاراً نعلّقه في المناسبات، ولا حلماً يُتداول في المجالس، بل تصور عميق وخطة طامحة، غايتها أن تمتد يدها إلى مختلف القطاعات، فتحسن مؤشرات الرفاه في التعليم كما في الصحة، وفي الاقتصاد كما في السكن، حتى لا ينصلح طرفٌ ويُترك الآخر. وما ذلك إلا سبيلٌ إلى الرؤية الجامعة التي نرجوها: رفاه مستدام، رفاه يثبت أثره فلا يتبدد مع الأزمات، ولا يخبو مع تقلب الأيام.
ولكي لا يبقى هذا المقترح حبيس الأوراق، فإن الرؤية تستدعي تشريعاً لإنشاء هيئة عامة للرفاه، يحدد رؤيتها، يمكّنها من الاستقلال مالياً وإدارياً، فتضع لائحتها التنفيذية أهدافها وآليات عملها، لتكون سامية في صلاحياتها، قادرة على مخاطبة جميع أجهزة الدولة لتزودها بالبيانات والإحصاءات التي تُعينها على التحليل والتخطيط. على أن ترفع توصياتها بشكل مباشر إلى مجلس الوزراء، ليُصار إلى دراستها واعتماد ما يحقق المصلحة العامة، إما عبر تعديلات تشريعية، أو سن قوانين جديدة، أو عبر قرارات وزارية وجهوية تُترجم التوصيات إلى واقع ملموس.
إن غايتنا من هذا المقترح ألا يُنظر إلى تحسين مؤشرات الرفاه على أنه ترف اجتماعي أو مسكّن نفسي، بل استثمار اقتصادي عميق، يضاعف العائد من الجسر الذي يصل بين جهد المرء وحاجاته المعيشية. فهذا الجسر – أي النقد – كثيراً ما يتمايل تحت رياح التضخم والاحتكار، فيُهدر من الجهد أكثر مما يوصل، فإذا ما أُصلح الجسر وأُحكم، صار العبور آمناً، وصار كل تعب يثمر نفعاً، وكل قطرة عرق تتحول إلى ثمرة صالحة.
ولأن الرفاه لا يقوم على السياسات الاقتصادية وحدها، بل تشارك فيها الثقافة والمعايير، فإن المقترح يستلزم أيضاً نهوضاً مجتمعياً عبر توجيه مؤسسي حكومي وغير حكومي، يعيد الاعتبار للبسيط الصادق، ويُطفئ بريق الزيف الذي يرهق الطبقة المتوسطة ويُثقل كاهلها بأعباء فوق طاقتها. وبهذا يبنى الرفاه على أساسٍ صلب، لا على صورٍ موهومة أو تفاخرٍ أجوف. فالغاية ليست مساواة الغني بالفقير، فذلك وهم يناقض طبائع الأشياء، وإنما تقريب الطبقات بعضها من بعض، حتى لا يظل الغني في سحابته والفقير في غباره، ويبقى الوسط عماد التوازن، وحارس الاستقرار. وهذا عين ما أشارت إليه الآية الكريمة: «لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ» (الحشر: 7)، لتظل الثروة أداة استقرار ورشاد، لا وسيلة تمايز وجور.
وهكذا، إن تحقق هذا المقترح، وغدت «رفاه» استراتيجيةً تتجدد أهدافها عبر «الهيئة العامة للرفاه»، صار بإمكان المجتمع أن يشهد ولادة رؤية أوسع وأسمى: رفاه مستدام، يورث للأبناء كما يورث لهم ميراث الكرامة والعدل.
الرفاه، إذن، ليس زخرف مالٍ ولا كثرة عدد ولا وهج مظاهر، بل هو معادلة دقيقة تتشابك فيها خيوط الاقتصاد بنُسج الثقافة، وتتعانق فيها السياسة بالقانون، ويتآزر فيها جهد الفرد مع وعي المجتمع. فإذا وُضعت الاستراتيجيات على بصيرة، وسارت الدولة فيها بحكمة، وأحسن الناس تلقّيها بفهمٍ وتقدير، ارتفع مؤشر الرفاه لا بزيادة في الرواتب وحدها، بل بسمو في الفكر، ورسوخ في العدل، واستقامة في المعيشة. وحينئذٍ يُقال إن الأمة قد أفلحت، لا بكثرة ما في الخزائن، ولكن بطيب ما في الحياة، وطمأنينة ما في القلوب، وثبات ما في القيم.
فاللهم أبرم لهذه الأمة أمراً رشداً، واجعلنا اللهم من الشاكرين لنعمتك، والقائمين بعدلك، والساعين إلى رشدك، إنك ولي ذلك والقادر عليه، ونعم المولى ونعم النصير.
«وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ» (التوبة: 105)