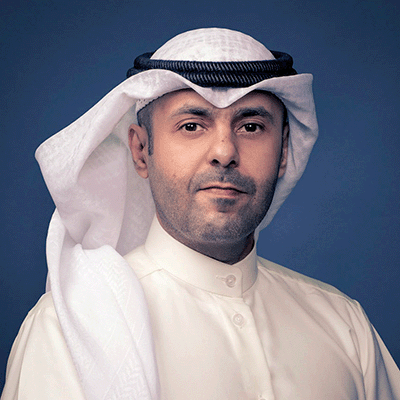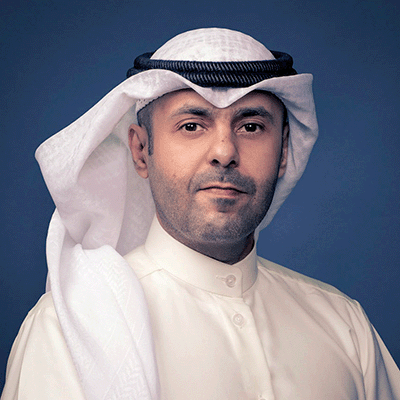نشرت في
2025/12/02 و تم طلب نسخة الطباعة في
2025/12/05
في جزئها الأول هذا، ما هذه القراءة إلا فاتحةٌ لسلسلةٍ ممتدّةٍ في ستة أجزاء؛ سلسلةٍ نَلتَمِس فيها فهم المسار الذي تمضي إليه منظومتنا الرقمية، ونفحص —بعين المحبّ لا الناقد— مَآلات الحكومة الرقمية إن مضَت بالنهج ذاته الذي انطلق منه تطبيق «سهل»، وما إذا كانت ترتقي إلى مفهوم الحكومة الذكية، ونستعرض التحديات التي تحول بين الرقمنة والأتمتة، ونقدّم منهجيات واستراتيجيات فنية من شأنها تقليص الفجوة، وتقصير المسافة، وتحقيق الغاية. إنها دراسة في الاتجاه قبل التفاصيل، وفي الإطار قبل الجزئيّات، تُمهّد لما بعدها من أجزاء تُكمل بعضها وتستضيء بما بدأناه هنا.
ولعلّ ما يضاعف الحاجة إلى هذه القراءة —في هذا التوقيت بالذات— أنّ مشروع رقمنة الدولة لم يعد شأناً تقنياً تُديره وزارة، ولا مشروعاً قطاعياً تُباشره جهة، بل أصبح ركناً من أركان هندسة الدولة الحديثة، وسبيلاً لا غنى عنه لبناء جهازٍ عامٍّ يستجيب بحكمة ويعمل بذكاء، وعصباً لا تقوم بدونه سياسات الحوكمة والشفافية وكفاءة الإنفاق. ومن ثَمّ، فإن تهيئة البنية الرقمية ليست مجرد تطوير خدمات، بل تأسيسٌ لمرحلةٍ تتطلّب من القيادة العليا نَظَرًا أشمل، وقراراً أعمق، وإرادةً تُحسن التقاط اللحظة التي يتهيّأ فيها البلد لانتقالٍ نوعيٍّ طال انتظاره.
وإن هذه السلسلة —بأجزائها الستة، وبما تتضمنه من تشخيصٍ وتوصيات— إنما تُقدَّم بوصفها معيناً لصاحب القرار، وذراعاً معرفيةً تُضيء له مواضع القوة والثغرات، وتُعين على استجلاء ما يحتاجه هذا التحوّل كي يكتمل وينضج؛ إذ لا ينهض مشروعٌ على هذا القدر من الأهمية إلا حين تتكامل فيه الرؤية السياسية مع الهندسة الفنية، وتتوحّد فيه إرادة الدولة مع أدواتها، فينهض المشروع على قدر ما تُهيَّأ له بيئته وتُصاغ له أُسسه.
وليس في هذه السلسلة أدنى رغبة في تثبيط عزائم القائمين على مشروع رقمنة الدولة، وشيّدوا بأيديهم جسور الربط بين الجهات، وصاغوا بوابةً تجمع ما تفرّق من خدمات؛ فلولا الله ثم تلك الجهود لما انكمشت المسافات، ولا انقضى زمن الطوابير، ولا غدت الهواتفُ بوابةً تفضي إلى معظم ما يحتاجه المواطن والمقيم. بل لولا فضل الله في نجاح «سهل» ما كنّا نتحدّث اليوم عن المآلات والتحديات؛ إذ لا يُبصَر العجز إلا بعد أن تظهر القدرة، ولا يُدار النقاش إلا حين يكتمل الأساس ويتهيّأ البناءُ لما هو أعلى وأرسخ.
وإنما الغاية هنا أن نضيء —بقدر الاستطاعة— ما خفي من جوانب المسار، وتقديم ما هو من جنس الواجب الوطني في زمنٍ يطلب من الجميع أن يسندوا هذا التحوّل بما استطاعوا من رؤية أو تحليل. فهذه الدراسة ليست سوى إسنادٍ يسير لجهود القائمين على المشروع، علّها تَرفِدُهُم بفكرة، أو تفتح لهم أفقاً، أو تعينهم على قراءة التحديات قبل أن تَستَعصِي. فنجاح هذا التحوّل لا يُبنى على التقنية وحدها، بل على وعيٍ متراكم، تتشارك فيه المؤسسات والكوادر، وتلتقي عنده الجهود التنفيذية على رؤيةٍ أوضح، ومسارٍ أشدّ استقرارًا.
الفضائل — ما ظهر من التحوّل قبل اكتمال بنيته
فتطبيق «سهل» ما جاء إلا ليكشف أن الدولة، متى شاءت، يمكنها أن تُعيد ترتيب علاقتها بمواطنيها على نحوٍ أيسر وأوضح؛ فهو ليس مجرّد نافذة إلكترونية، بل محاولة أولى لتجميع شَتات الخدمات —وإن كان بعضها— في بوابةٍ واحدة، تُغني —فيما يغنيه— عن الترحال بين المواقع، وتختصر من الزمن ما كان يستنزف الأعصاب قبل الجهد. ولعل أولى مزاياه أنه حرّر المواطن من طابور الانتظار، وجعل الهاتف بوّابة الدولة، يطرقها متى شاء، فيجد إشعاراته حاضرة، ومعاملاته ماثلة، وخدماته تُستَكمَل بلا استئذان ولا استِرحام؛ فكأنما انكمش الزمن، وتبدّد الاحتكاك، وانتقل العبء من كتف المراجع إلى منظومة رقمية تسعى نيابة عنه.
ثم إن «سهل» —على حداثة تجربته— حمل في طيّاته بذور التحوّل الأعمق؛ فقد دفع الوزارات إلى قدر من الانضباط بواجهات رقمية متقاربة، وإعادة تَهذيب بياناتها، وتوحيد مساراتها، أملا بأن تعمل المنصة دون تعثّر. وهنا تكمن قيمته الكبرى: أنه أرسى، ولو بقدرٍ محدود، مبدأ التكامل بين الجهات، وربط الأنظمة القديمة بجسور جديدة من واجهات البرمجة والمصادقات الموحّدة، فخفّض قدراً من الأخطاء، ورفع مستوى الشفافية، وأظهر للناس أين تقف معاملاتهم، وأين تتعثر. ذلك كله منح الدولة فرصة لخفض التكاليف التشغيلية، وتخفيف الازدحام في مراكز الخدمة، وأقرب إلى إدارة الجودة منها إلى إدارة الطوابير.
بيد أنّ القيمة الأعمق في «سهل» ليست في الخدمات التي يقدّمها، بل في الفكرة التي يرمز إليها: أن التحوّل الرقمي ليس تجميلاً للواجهة، بل إعادة صياغة لروح الدولة ومنهجها في العمل. فهو خطوة انتقالية نحو الحكومة الذكية التي تسعى لأن تتعامل مع البيانات قبل الخدمات، ومع المنظومة قبل الواجهة؛ تربط المؤسسات كما تربط الناس، وتؤلف بين الأنظمة كما بين الخدمات، وتعلّم المؤسسات أن الزمن الرقمي لا يحتمل التعقيد ولا ازدواجية الجهد، ولا يرضى بالمسارات المتوازية التي لا تلتقي. وبذلك يصبح «سهل» —رغم قصوره الطبيعي— لحظةً فارقة في رحلة الإدارة العامة الكويتية نحو دولةٍ أكثر رشاقة، وأبعد عن أثقال الورق وصخب المراجعات.
المآلات — ما تكشفه البنية عند الامتحان
لم يكن بوسع المنظومة الرقمية، بالصورة التي آلت إليها اليوم، إلا أن تكشف نتائج هي في باطنها ثمرةٌ طبيعية لتحديات كبرى؛ فمع ازدياد الاعتماد على «سهل»، اتّسعت الفجوة بين ما تَعِد به فكرة التحوّل الرقمي وبين ما تسمح به البنية المؤسسية الراهنة. فأضحى التطبيق قادراً على إتمام الخدمات اليسيرة وحسب، عاجزاً عن قيادة الرحلات الخدمية المعقّدة التي تعبر أكثر من جهة وتتناوب عليها أكثر من صلاحية وتتشابك فيها الجهات والموافقات، وتتطلب مسارات متعددة لا يجمعها نظام أمّ، ولا يوحّد منطقها مركزٌ واحد. وتضاعفت، تبعاً لذلك، ازدواجية الجهد داخل الوزارات؛ إذ تُراجِع كل جهة ما يردها من المنصة كأنها تراه للمرة الأولى، فتتكرّر المراجعات، وتُعاد الخطوات ذاتها، ويتبدّد الوَفر التشغيلي الذي كان يُفترض أن تمهّد له الرقمنة وصولًا إلى الأتمتة.
ثم يبرز إلى جانب ذلك أثرٌ لا يقلّ وطأة: تزايد الأخطاء الناجمة عن تباين قواعد البيانات واختلاف منطق تخزينها بين الجهات، فبات المستفيد يرى في «سهل» معلومة، وفي منصة الجهة معلومة أخرى في بعض الأحيان، وفي أحيانٍ ثالثة يتلقّى ردّاً يناقض ما تُظهره الشاشتان معاً. ومع غياب الربط اللحظي في بعض المواضع، ازدادت المفارقة بين ما يراه المواطن على شاشته وما يراه الموظف على نظامه، وبرز الشعور بأن الرقمنة ليست قطيعةً مع الورق، بل امتدادٌ ممهّد له في هيئةٍ محسّنة؛ وأن التطبيق، مهما حسُن، لا يقدر أن يحجب ما في البنية من انفصال، ولا أن يجمّل ما بين الأنظمة من تَباعد.
وتعاظم أثر هذا الاضطراب البنيوي على قدرة الدولة على الابتكار، إذ لا يمكن لدولةٍ أن تبني خدماتٍ استباقية أو مؤتمتة فوق بنيةٍ يتباعد فيها المنطق قبل التقنية، ولا لبوابةٍ واحدة أن تمحو آثار غياب السياسات المركزية، أو اختلاف ثقافة العمل، أو تباين نماذج البيانات بين الجهات. فغياب «الحقيقة الواحدة» جعل تتبّع المعاملات أمراً مرهقاً ومفتقراً إلى اليقين، وأعاق قدرة الدولة على اتخاذ قراراتٍ آنية تنبني على بياناتٍ مترابطة ومتكاملة. ونتج عن ذلك تعذّر إنشاء لوحة وطنية موحّدة للأداء، وتقلّص القدرة على قياس الزمن الفعلي للمعاملة بقياسٍ واحد لا يختلف بتغيّر الجهة، أو رصد نقاط التعطل، أو تحديد الجهة المسؤولة عن البطء. وكلها متطلباتٌ لا غنى عنها في أي منظومة ذكية.
وارتفعت التكاليف التشغيلية في بعض الجهات بدلًا من أن تنخفض كما كان منتظرًا من الرقمنة، إذ اضطرّت إلى تضخيم فرق المتابعة لمجاراة تدفّق الطلبات الواردة عبر المنصة، دون امتلاك الأدوات التقنية التي تُمكّنها من مواكبته بكفاءة. وتزايد الاعتماد على التواصل الهاتفي والمراسلات غير الرسمية لسدّ الفراغ الذي خلّفه غياب نظام مساءلة رقمي، فاختلط ما هو رسمي بما هو شخصي، وتآكل —شيئًا فشيئًا— ما كان يُفترض أن تحققه الرقمنة من شفافية واستقرار مؤسسي.
إنّ هذه المآلات كلها —بما تحمل من تفاوتٍ وثقلٍ وتأخّرٍ في نضج التجربة— لا تُعدّ إخفاقاً، بقدر ما هي انعكاسٌ مباشر لطبيعة التحديات التي ستتناولها هذه القراءة؛ تحدياتٌ لا تُفهَم نتائجها إلا إذا أُحيط بسياقها، ولا تُعالَج إلا إذا وُضِع كل جزء من المنظومة في موضعه الذي يليق به من مسار الدولة الذكية.
التحديات — ما يحول بين الرقمنة والدولة الذكية
وإذ تمهّد هذه القراءة لانطلاق سلسلةٍ تمتدّ إلى خمسة أجزاء لاحقة، فإن كل جزءٍ لاحقٍ منها سيتناول —في تمام الساعة الـ 5:00 مساء كل ثلاثاء— محورًا من محاور تلك التحديات التي تحول بين النموذج الحالي لـ «سهل» والنموذج الأمثل للحكومة الذكية، وسيُفصَّله بإسهابٍ يليق بثقله وخطورته، وسيُحيط بما يلزمه من منهجياتٍ وأُطرٍ فنية وعمليةٍ تُعين على تذليل ما فيه من تعقيد، وتتقصّى ما وراءه من تبعات. فالمسألة ليست تعداداً للعقبات، بل قراءة للطريق من أوله إلى منتهاه؛ قراءة ترسم للمؤسسات المعنيّة ما يمكن أن يكون عليه البناء الرقمي حين يُعاد تأسيسه على قواعد أوثق، ومسارات أوضح، ونُظمٍ أقدر على خدمة الوطن والمقيم، في زمنٍ لا يُحسِن الانتظار.
أولاً: المحور البنيويّ- غياب «العقل الرقميّ الجامع»: إن أعظم ما يعوق «سهل» اليوم هو غياب «النظام الأم» الذي تُفضي إليه الخيوط كلها؛ ذلك العقل المركزي الذي يوحّد شكل البيانات، ويضبط منطق الخدمات، ويفرض على الوزارات لغةً واحدة في المصادقات والتدقيق. فـ«سهل» —على جلالة أثره— ليس أكثر من بوابة تتلقّى ما يردها من منظوماتٍ متباعدة؛ لا يملك سلطة فرض التوحيد، ولا قدرة على توليف المسارات، ولا عقلًا رقمياً مركزيًا يُعيد ترتيب دورة الخدمة من جذورها. ومع انعدام هذا «العقل الجامع»، تبقى كل جهة تعمل في جزيرتها التقنية، فينشأ التباين، ويضعف الانسجام، وتتعذّر ولادة خدمة وطنية متكاملة تُدار من مركز واحد، كما تفعل الحكومات التي بلغت مرحلة الذكاء المؤسسيّ.
- شتات «هندسة البيانات الوطنيّة»: وما دامت الوزارات تبني أنظمتها بمنطقٍ متفرّق، فإن التكامل سيظلّ تكاملاً «ترضوياً» لا «هيكلياً» —أي قائماً على الحدّ الأدنى من التوافق—. فكل جهة تصوغ قواعد بياناتها وفق رؤيتها الخاصة: حقول تختلف، ونماذج تتباين، وآليات للتحقق لا تشبه ما لدى الجهة الأخرى، ودورات للموافقة تُدار بمعايير متباعدة. ومع هذا الاضطراب البنيوي، يجد «سهل» نفسه مجرد مترجم يحاول التوفيق بين لغات لا تلتقي، في حين أن التحوّل الرقمي الحقّ لا يتحقق إلا بإعادة هندسة الخدمة من أصلها، وتوحيد قاموس البيانات، وإرساء نظام يجعل «البيان الواحد» أساساً لكل جهة، لا نسخةً تتناسل عنها عشرات الاختلافات. وحين لا يُفرض هذا التوحيد، يظلّ التكامل هشاً، محكوماً بما تسمح به المنظومات القديمة، لا بما تتطلبه الحكومة الذكية من انسجام كامل بين البيانات والمنطق الإداري.
- سطوة «النموذج الورقيّ الموروث»: ولعلّ أعمق التحديات يكمن في البيروقراطية الوراثية التي صُممت لها المعاملة منذ زمن الورق؛ خطواتٌ تتتابع كما تتتابع الأختام، وحضورٌ يشترط التوقيع والمراجعة، ومستندات تُرفق لا للتحقق، بل لحفظ الطقوس الإدارية ذاتها. فلما انتقلت المعاملة إلى الفضاء الرقمي، حُمِلت معها هذه الطقوس كما هي، فغدت «إلكترونية الشكل، ورقية المضمون». وهنا يقع «سهل» في مأزقٍ لا يُلام عليه: إذ لا يستطيع أن يحوّل الخدمة إلى خدمة ذكية ما لم تُعاد هندستها من الأساس، ولا يمكنه أن يتجاوز منطق الورق ما دام الورق هو الذي صاغ خطوات الخدمة أول مرة. وهذه البيروقراطية —ما لم تُنقَّح وتُختصر وتُبنى على منطق رقمي خالص— ستظلّ تمنع التحول من بوابةٍ حديثة إلى دولةٍ ذكية تعمل بالاستباق لا بالانتظار، وبالبيانات لا بالتواقيع؛ دولةٌ تَصنع الخدمة قبل أن تُطلَب، لا دولةٌ تُعيد إنتاج الورق بلونٍ إلكترونيّ.
ثانياً: المحور التقنيّ- انقطاع «النَّبض الرقمي» بين الأنظمة: من بين ما يثقل خُطى «سهل» أن الربط بينه وبين أنظمة الجهات ليس بالضرورة ربطاً لحظياً كاملاً، بل يقوم في لبّه على خدماتٍ ويب وواجهاتٍ برمجية تتعامل مع نظمٍ تتبع تحديثاً غير لحظي في بعض الأحيان، فينعكس ذلك تأخراً في تحديث البيانات، أو تفاوتاً بين ما يراه المستخدم في التطبيق وما يراه الموظف في نظام الجهة، أو توقفاً مؤقتاً عند اشتداد الضغط. وهكذا يغدو «سهل» —عند بعض المراجعين— واجهةً تُظهر الخدمة على نحوٍ منسّق، بينما البيانات خلفها تتحرّك بإيقاعٍ غير متزامن، في حين أن الحكومة الذكية لا تقوم إلا على تدفّقٍ آنيٍّ ثابت للمعلومة، يجعل كل نقرةٍ على الشاشة انعكاساً مباشراً لوضع المعاملة في النظام الأم. وما لم يُعالَج هذا الخلل التقني؛ ستبقى الثقة بالتطبيق معلّقة بين ما يُعرض على الشاشة وما يجري في كواليس الأنظمة المتباينة إيقاعاً وأداءً.
- تعثّر «المفتاح الواحد» للدولة الرقمية: ثمّة تحدٍّ آخر لا يقل خطورة، هو أن هوية الدولة الرقمية لم تُستوفَ بعد شروطها الكاملة؛ فالمنظومة المخصّصة للتعريف بالمواطن والمقيم، وإن وُجدت، لم تُدمَج اندماجاً تاماً في منظومات الجهات، ولم تُستثمَر بوصفها «مفتاحاً واحداً» لكل خدمة، يغني عن تكرار البيانات والنماذج. والنتيجة أن المستخدم —على الرغم من دخوله بهوية رقمية موثوقة— يجد نفسه يعيد ملء الحقول ذاتها، ويرفع المستندات ذاتها، وكأن الدولة لا تعرفه إلا بقدر ما يكتبه لها كل مرة. الحكومة الذكية الحقة تبدأ من هويةٍ موحّدة تُستدعى منها البيانات تلقائياً، فتتحوّل البوابة —حقاً— إلى «حكومة بلا نماذج»، لا إلى منصة تطلب من المواطن أن يقدّم للدولة ما تعرفه عنه سلفاً.
- اتّساع «سطح الهشاشة السيبرانية»: وإذا كان «سهل» قد فتح جسور الربط بين الأنظمة، فقد فتح معها تحدياً موازياً في الأمن السيبراني؛ فكل وزارة اليوم تملك مستوى حماية يختلف عن سواها، من حيث البنية، والسياسات، والخبرة الفنية. ومع اتساع شبكة الربط عبر المنصة، يزداد ما يُعرَف في أدبيات الأمن بـ«سطح الهجوم»، فتتعاظم احتمالات الثغرات، ويغدو أي ضعفٍ في جهة واحدة منفذاً محتملاً إلى غيرها. هنا لا يعود الأمن مسؤولية كل وزارة على حدة، بل واجبَ دولةٍ، لذلك، تضع سياسةً مركزية صارمة، ومعايير موحدة للتشفير، وإدارةً عليا للمخاطر السيبرانية ترقب المشهد كله من علٍ. فالحكومة الذكية، إن لم تُحصّن بقدر ما تُربط، قد تتحوّل من نعمة تسريعٍ للخدمات إلى ثغرةٍ تمسّ ثقة الناس في المنظومة برمتها.
ثالثاً: المحور الحوكميّ- تشتّت «السيادة البيانية» للدولة: من أبرز ما يكشف عمق الفجوة في المنظومة الرقمية أن الدولة لم ترسِ بعد سياسة بيانات وطنية موحَّدة تُلزم الجهات بمعايير واحدة للتخزين، والتصنيف، والحماية، وتبادل المعلومات. فكل وزارة، في الغالب، تُدير بياناتها وفق اجتهادها الخاص: تخزينٌ يختلف في بنيته، وتصنيفٌ لا يخضع لمرجعية وطنية، وبروتوكولات اتصال تُصاغ حسب قدرة كل جهة لا حسب حاجة الدولة. وهكذا تتوالد «جزر معلومات» يصعب ربطها أو التحقق من دقّتها أو ضمان سلامتها، حتى تبدو كل وزارة —من منظور البيانات— دولةً صُغرى داخل الدولة. ولا يُبنى التحوّل الرقمي في لبّه على واجهات الخدمات، بل على وحدة البيانات وأمنها ومنطق تداولها؛ فإذا تباينت هذه الأسس، تعذّر بناء منظومة ذكية تُدار من مركز واحد، مهما بلغت جودة البوابات أو حداثة التطبيقات.
- انعدام «مرآة الأداء الوطني»: ولا يقلّ خطورة عن ذلك غياب نظام مساءلة رقمي يكشف أداء الخدمات عبر معايير وطنية واضحة يُحتكم إليها. فلا توجد اليوم لوحة مركزية تُظهر الزمن الفعلي لإنجاز الخدمة، ولا تُبيّن أسباب التأخير، ولا تُحدّد أين تُحتجز المعاملة، ولا أي الجهات أبطأ إنجازاً أو أكثر تعطّلاً. وفي غياب مؤشرات أداء مُلزمة ومرتبطة بمجلس الوزراء، يبقى التطوير مجهوداً اجتهادياً تبذله بعض الإدارات، لا مساراً إلزامياً يحكمه هدف وطني مشترك. إن الحكومة الذكية لا تقوم على التقنية وحدها، بل على الشفافية والمساءلة؛ وحين لا تُقاس الخدمة ولا يُعرَف موضع الخلل، يستحيل إصلاح المنظومة أو رفع كفاءتها، مهما تطوّر التطبيق الذي يقف في الواجهة.
- تباين «الثقافة التشغيلية» بين الجهات: ثمّة تحدٍّ متجذّر لا يُحلّ بالتقنية، بل بالإنسان: اختلاف ثقافة العمل بين الجهات. فبعض المؤسسات تمتلك فرقاً تقنية قادرة، ومنفتحة على التطوير، مستعدة لإعادة هندسة الخدمة وتحديث أنظمتها، بينما أخرى تتوجّس من تبادل البيانات، وتتمسّك بدورات عمل قديمة، أو تفتقر إلى الخبرة التي تمكّنها من مواكبة التحوّل الرقمي. وفي هذا التباين تتعثر أي محاولة للتكامل، إذ يصبح «سهل» واجهةً واحدة تُغطّي منظومات لا تشترك في الرؤية ولا في الإيقاع. والتحول الرقمي الحقيقي لا يتحقق إلا حين تتقارب ثقافات الجهات، وتقتنع بأن الخدمة الوطنية ملكٌ للمستخدم لا للمؤسسة، وأن بنية الدولة الرقمية لا تستقيم ما دامت الوزارات تعمل بمعايير متنافرة، ومنهجيّاتٍ لا تلتقي.
رابعاً: المحور الاستخداميّ- عدم اتساق «التجربة الرقمية للمستخدم»: وعلى الرغم من أن «سهل» يمثّل نقلة نوعية في تبسيط الوصول إلى الخدمة، وفي إعادة تشكيل علاقة المستخدم بها، فإن شريحةً واسعة من المستخدمين لا تزال تواجه صعوبة في التعامل مع المنصّة، لا لقصورٍ فيها بالضرورة، بل لتباين الخبرة الرقمية بين فئات المجتمع. فكبار السن، والمقيمون الجدد، ومن لم يألفوا استخدام التقنيات الحكومية من قبل، يجدون الواجهات أكثر تعقيداً مما ينبغي لمن لم يتشرّب لغة المنصّات الرقمية الحكومية، والخطوات أقل وضوحاً مما يتوقعون، فيضطرّ بعضهم إلى طلب المساعدة من موظفين أو أقارب لإتمام أبسط المعاملات. وإذا كان التحوّل الرقمي غاية وطنية، فإن نجاحه مرهون بأن يشعر كل مستخدم، مهما اختلفت خبرته، بأن المنصة تكلّمه بلغته، لا بلغة التقنية وحدها؛ وأن الخدمة مصمّمة له، لا لمستخدم مثالي لا وجود له إلا في دفاتر المصممين.
- تَضَخُّم «حاجز التوقّعات المجتمعية»: ومن التحديات التي يندر الالتفات إليها أن الجمهور —بحكم ما يراه من تطور تقني حوله— يتوقع من «سهل» ما لا تحتمله البنية الحكومية القائمة بعد. فكثيرون يظنون المنصة نظاماً مركزياً للدولة أو حلاً جذرياً لكل التعقيدات، أو بوابةً تتولى بالنيابة عن الدولة كامل الرحلة الخدمية، من أولها إلى آخرها، بينما هي في حقيقتها بوابةٌ تربط أنظمة غير موحدة، وتعرض ما تسمح به هذه الأنظمة من بيانات وخدمات. ومع اتساع هذه الفجوة بين التوقع والواقع، تتزايد الشكوى، لا لأن «سهل» قصّر، بل لأن الناس تقيسه بمعيار الحكومة الذكية المكتملة، لا بوصفه مرحلة انتقالية. والحكمة هنا أن يُضبط الخطاب العام، وأن تُعرَّف المنصة بحدود دورها كما تُعرّف بقدراتها، وأن يُعرّف المستخدم بما يمكن للمنصة أن تؤديه الآن، وما يحتاج إلى إصلاحٍ مؤسسي قبل أن ينعكس على شاشة الهاتف.
خامساً: المحور المفهوميّ- اختلاط «حدود الدور المؤسسي»: إنّ لبّ الإشكال في التجربة الراهنة لا يكمن في أداء التطبيق، بل في التصوّر الذي تُعلّق عليه الآمال بما يتجاوز حقيقته. فـ«سهل» ليس الدولة، بل بوابتها؛ يعرض ما تسمح به الأنظمة القائمة، لا ما تستلزمه الحكومة الذكية من وحدة بيانات وهيكلة موحّدة. فالتطبيق —مهما حسنت واجهاته— لا يملك سلطة جمع البيانات ولا حقّ فرض التناسق بين الوزارات، ولا قدرة على إدارة منطق الخدمة من أصلها. وما لم تُبنَ البنية العميقة للدولة على قواعد موحّدة، يظلّ التطبيق ظلاً للبنية القائمة، لا قوةً تقود التحوّل أو تصنع مساره.
- غياب «العقل الحاكم لما وراء الواجهة»: فالتطبيق ليس منصة بيانات وطنية تُستقى منها «الحقيقة الواحدة»، ولا بروتوكول دولة يفرض دورة خدمة منضبطة، ولا نظام هوية يستدعي البيانات دون نماذج، ولا مركز قرار يُشغّل الخدمة تلقائياً متى تحقق شرطها، ولا محرك تنبؤ يُدرِك الاحتياج قبل طلبه، ولا حكومة ذاتية التشغيل تعمل بالاتساق دون تدخل بشري. هذه كلها وظائف جهاز الدولة الرقمية، لا وظائف بوابة الخدمات. وأخطر ما في المشهد أن الناس —بحسن الظن— تنسب للتطبيق ما هو من شأن البنية المؤسسية، وتلومه على ما لا يملك أدواته، ولا يملك الحق في صناعته.
فالتساؤل الذي تقود إليه السلسلة: ماذا لو لم تُعَد هيكلة الدولة رقمياً من الأصل، وظلّت الأنظمة تعمل بمنطق الجُزُر؟ هل يمكن لـ«سهل» —بعد طرح الحلول الممكنة لكلّ محور في الأجزاء القادمة— أن يتجاوز دوره كنافذة، وأن ينهض بما لا تنهض به البنية المؤسسية من تحوّل شامل؟ ذلك هو السؤال الذي يقف عند خاتمة الطريق، وسنعود إليه في نهاية هذه السلسلة لنرى: هل يُعاد تعريف «سهل» ليضيق بما يضيق به اليوم ويتسع لما ينبغي، أم تُعاد صياغة الدولة ذاتها لتتّسق مع مشروع ذي طبيعة مختلفة؟
فاللّهم أبرِم لهذه الأمّة أمرًا رشدًا..