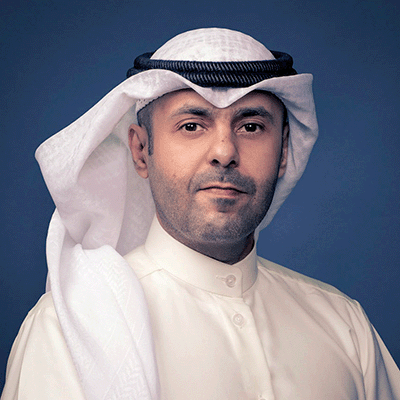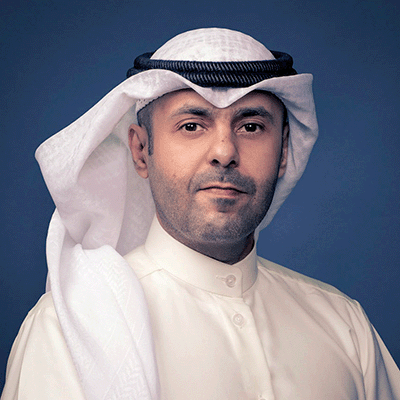نشرت في
2020/04/13 و تم طلب نسخة الطباعة في
2024/07/27
نشر في
[القبس]
ما كان للتداعيات الوقائية في بداية الأزمة الصحية إلا أن تنعكس سلبا على السلوك الاستهلاكي في جميع دول العالم، صانعةً بذلك انخفاضا حادا في حجم الطلب على مخزون مصانع العالم في شتى المجالات. لينتج من مزيج هذا وذاك انخفاضا حادا في الطلب على النفط، عالميا.
وقبل الخوض في المسألة النفطية، علينا إدراك أهمية القطاع الصناعي في إكمال ديمومة الاقتصاد العالمي، إذ أنه لا يقل أهمية عن القطاعات الأخرى. فالقطاعين النفطي والصناعي يكمل بعضهما الآخر، فلا قيمة لقطاع نفطي لا يُستغل من قبل قطاع صناعي، كما لا يمكن لقطاع صناعي أن يقوم بغير قطاع نفطي، ولكنه وفي الوقت ذاته يعتمد على استهلاك عالمي. أي بمعنى آخر، أن القطاع الصناعي هو حلقة الوصل الأساسية بين القطاع النفطي والقطاع الاستهلاكي.
اندلعت نيران الأزمة النفطية بشرارة تعثر القطاع الاستهلاكي نتيجة للتداعيات الوقائية من وباء كورونا. وما لهذا التعثر إلا أن ينعكس على القطاع الصناعي بإجراءات تحوطية لموازنة كلفة التصنيع مع الانخفاض الجديد في الطلب على المنتجات. وبلا شك، تأتي تلك الموازنة الجديدة متمثلة في انخفاض حاد في الطلب على النفط العالمي.
ومع بداية الأزمة الصحية، اجتمعت «أوبك بلس» للاتفاق على خفض الإنتاج العالمي بغية رفع سعر برميل النفط بهدف تحقيق الربحية للدول المصدرة، اعتقادا منها بأن تعثر القطاع الاستهلاكي لن يدوم طويلا. ولكن، عادت أطراف الاجتماع خاوية الوفاض من دون اتفاق، الأمر الذي جاء برد فعل عكسي من المملكة العربية السعودية مغرقةً بدورها سوق النفط، لتنخفض الأسعار، بغية استهداف أكبر حصة سوقية ممكنة قد تلتهمها روسيا أو دول أخرى لم توافق على محاور هذا الاجتماع.
وكنتيجة حتمية لهذا الإغراق انخفض سعر البرميل، مما صنع جبهات سياسية معادية لتصرف المملكة، والذي يصب في صالح شركات النفط الصخري الأمريكية ذات تكلفة الإنتاج المرتفعة، متناسية أو غير مبالية للتوازن الاقتصادي الذي قامت به المملكة —بقصد أو بغير قصد— من تخفيض العبء على القطاع الصناعي في محنته تجاه القطاع الاستهلاكي، ورب رميةٍ من غير رام!
ولكن، لكل منا فرصه ليقتنصها، ويتحوط بها. فنتاج تلك الصراعات أتاح للصين، ولدول صناعية أخرى أن تلعب دورها في المشهد مستغلة انخفاض سعر برميل النفط بزيادة الطلب عليه والاستثمار في تخزينه تحوطا من ارتفاعه مستقبلا. وبناء على ذلك، فإن حجم الطلب على النفط لا يعد حجما «حقيقيا» مرتبطا بحجم قطاع استهلاكي مستدام، إنما حجما «مصطنعا» لارتباطه بعوامل أخرى في الوقت نفسه.
وتبعا للضغوطات السياسية في جميع الدول النفطية، تجتمع «أوبك بلس» مرة أخرى معلنة اتفاقها بخفض إجمالي الإنتاج ١٠ مليون برميل نفط يوميا، اعتقادا منها بأن الأمر سيصب في صالح الديمومة الاقتصادية العالمية.
الآن، تجرنا الأحداث لنعود إلى القطاع الصناعي الذي لن يتمكن من تحمل ضربتين في وقت واحد لمدة زمنية طويلة. فالضربة الأولى تلقاها من القطاع الاستهلاكي، وأما الثانية فأتت من القطاع النفطي بعد الاجتماع الثاني. فمع الانخفاض المتزايد على الطلب الاستهلاكي نتيجة لتداعيات الأزمة الصحية، ومع انخفاض المعروض من النفط عالميا، سترتفع كلفة الإنتاج الصناعي عالميا، وبشكل متصاعد. هذا الارتفاع الذي يشكل تربة خصبة لتشكيل الظروف القاهرة في القطاع الصناعي، منتجة انكماشا حادا في حجمه. ومع هذا الانكماش الحاد ينخفض المعروض الاستهلاكي عالميا بشكل أكثر حدة، صانعا ارتفاعا بأسعار المنتجات نتيجة لثبات الطلب نسبيا أو انخفاضه بشكل أقل حدة.
ومن الجانب الأخر، وبعد الاجتماع الثاني تحديدا، ستتمتع الدول النفطية بارتفاع تدريجي بسعر برميل النفط، وبشكل مؤقت، ينتهي ببدء تداعيات الظروف القاهرة سالفة الذكر في القطاع الصناعي، إذ سنرى الانخفاض الحقيقي في الطلب على النفط نتيجة لبداية انكماش القطاع الصناعي تدريجيا. حينها وحينها فقط، سنشهد انخفاضا في سعر برميل النفط حتى أدنى مستوياته نتيجة ارتفاع المعروض منه بالتزامن مع انخفاض الطلب عليه. وفي الوقت ذاته، سنرى أسعار المنتجات الاستهلاكية في أعلى مستوى لها نتيجة انخفاض المعروض منها بنسبة تفوق نسبة انخفاض الطلب عليها.
إن اتفاق «أوبك بلس» جاء اعتياديا، وقد يكون مقبولا في أزمة سياسية أو صناعية. ولكننا اليوم نشهد أزمة صحية وتشغيلية على مستوى العالم بأسره، هذه الأزمة تمكنت منا حتى أخلت بموازين القطاع الاستهلاكي. «أوبك بلس» في اتفاقها هذا، لم تراع الصورة الكبرى في الديمومة الاقتصادية، بل جاءت بحل دون ذلك، مراعية الدول والشركات المنتجة للنفط فقط، وبشكل مؤقت، بتصرف سيقلب موازين الاقتصاد العالمي رأسا على عقب. وإذا لم تحل الأزمة الصحية بأقرب وقت ممكن، فإننا أقرب للكساد من أي وقت مضى.