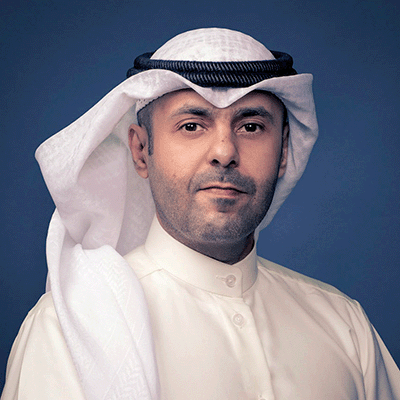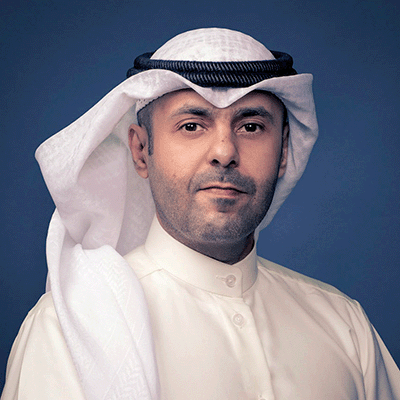نشرت في
2026/01/06 و تم طلب نسخة الطباعة في
2026/01/30
اضغط هنا لتحميل السلسلة كاملة بصيغة PDF.
الجزء السابق •
«سهل» والأتمتة الكبرى: رابعاً — محور التحدّيات الحوكميّة
في الأجزاء السابقة من هذه السلسلة، مضينا من البنية إلى التشغيل إلى الحوكمة: فككنا «الجسد الرقميّ» في المحور البنيوي، ثم أوصلنا إليه «النَّبض التقنيّ»، ثم وضعنا فوقه «سيادةً حوكميّة» تُمسك بمركز القرار، وتُحكم سيادة البيانات، وتبني مرآة الأداء الوطني. غير أنّ هذا كلّه —مع ما فيه من عمقٍ وأهمية— يبقى في نظر المواطن والمقيم «غيباً مؤسسياً» لا يراه؛ فما يبلغه في النهاية هو شاشة، وخطوات، ورسالة نجاح أو فشل. هناك، عند نقطة التماسّ بين الإنسان والدولة، تُختَصر كلّ هذه الطبقات في تجربةٍ واحدة: إمّا أن تكون بيّنة ميسّرة تُشعره بأن الدولة تعمل لأجله، أو تكون متعثّرة غامضة تعيد إنتاج الشعور ذاته الذي كانت تصنعه طوابير الأمس.
من هنا، لا يُنظر إلى «المحور الاستخداميّ» بوصفه مساحةً تجميلية تُعنى بالواجهات والألوان، بل بوصفه امتحاناً عملياً لكلّ ما سبق من بروتوكول وحوكمة وبنية؛ فإن عجزت الدولة عن تحويل هذه الطبقات إلى تجربةٍ مفهومةٍ وعادلةٍ وقابلةٍ للانتفاع، ظلّ التحوّل الرقميّ مشروعاً داخلياً لا يبلغ مقصده. وفي هذا الجزء الخامس، نعيد قراءة التحدّيات الاستخداميّة لا كملحقٍ تقني، بل كمحورٍ يقرّر —في نهاية المطاف— كيف سيحكم المجتمع على جدوى هذا التحوّل برمّته.
تشتّت التجربة الرقميّة.. حين تتكلّم الدولة بواجهاتٍ متنافرة
أوّل التحدّيات الاستخداميّة وأكثرها ظهوراً هو عدم اتّساق التجربة الرقمية للمستخدم عبر «سهل» وخارجه. فالمواطن —حين ينتقل بين خدمةٍ وأخرى، أو بين جهةٍ وأخرى— يجد نفسه أمام مفرداتٍ تتغيّر، وخطواتٍ تتباين، ورسائلَ لا تتّفق في المنطق ولا في النبرة. فيدخل خدمةً تَطلُب منه الحقول ذاتها بطريقةٍ مختلفة، وأخرى تُخبِّئ أهم خطوةٍ في سطرٍ جانبيّ، وثالثة تُلقي إليه برسالة خطأٍ لا تبيّن له ماذا يفعل لاحقاً. وهكذا يصبح على المستخدم أن يتعلّم «لغة كل جهة»، بدلاً من أن تلتزم الجهات بلغةٍ وطنيةٍ واحدة في مخاطبته.
هذا التشتّت ليس خطأ تصميمٍ موضعيّاً، بل نتيجة بنيويّة لغياب «نظام تجربة مستخدم وطنيّ» يوازي في مستواه «البروتوكول العام للحكومة الذكية». فإذا كان البروتوكول قد وحّد لغة الأنظمة فيما بينها، فإن المحور الاستخدامي يقتضي توحيد لغة الدولة مع مستخدميها: مصطلحات ثابتة للحالات، أنماط متكرّرة للنماذج، سلوكاً متوقعاً للأزرار، منطقاً موحّداً للتنقّل بين المراحل. فكما لا يُسمح للجهات أن تبتكر قاموساً خاصّاً للبيانات، لا ينبغي أن يُترك لكلّ جهة أن تبتكر تجربةً خاصّة للمستخدم تُربكه بدل أن تخدمه.
الحلّ هنا ليس في فرض واجهةٍ واحدة جامدة على الجميع، بل في بناء «نظام تصميم وتجربة» (Design System) وطنيّ ينبثق من «البروتوكول العام» ويُرسى في وثيقةٍ مُلزِمة، تُحدّد: أنماط العناصر، تسلسل الخطوات، قواعد الكتابة على الشاشة، أشكال رسائل النجاح والخطأ، طرق طلب الموافقة، وكيفية عرض الزمن المتوقَّع لإنجاز الخدمة. ثم تُدمَج هذه القواعد في «البيئة البرمجية للبروتوكول» بحيث لا تُدرَج خدمةٌ عبر «المنصّات الوطنية الموحّدة» إلا إذا امتثلت لهذا النظام كما تمتثل لقواعد الربط والتكامل.
النتيجة المتوخّاة أن يشعر المستخدم —أيّ خدمةٍ استعمل، وأيّ جهةٍ خاطب— بأن الدولة تخاطبه بوجهٍ واحد، وإن تعدّدت الجهات خلف الشاشة؛ فيطمئن إلى أن ما تعلّمه في خدمةٍ سابقةٍ ينفعه في خدمةٍ لاحقة، وأنه أمام «منطقٍ وطنيّ» ثابت، لا أمام تجارب متنافرة لا يربط بينها إلا اسم التطبيق.
الفجوة الرقميّة.. من يُمسك بيد من لم تُمسك يده الشاشة من قبل؟
التحدّي الثاني في المحور الاستخداميّ هو الفجوة الرقميّة بين فئات المجتمع. فحين نتحدّث عن تجربة المستخدم، لا يجوز أن نتخيّل دائماً مستخدماً شاباً، متمرِّسًا بالهواتف الذكية، قادراً على القراءة السريعة ومتابعة التعليمات. أمام الدولة فئاتٌ أخرى: كبار سنّ لا يألفون شاشاتٍ صغيرة، مقيمون حديثو العهد باللغة، ذوو إعاقة بصريّة أو حركيّة، أو مواطنون لم يعتادوا التعامل مع المنصّات الحكومية إلا عبر مكاتب الخدمة التقليدية. فإذا صيغت التجربة الرقمية بمعيار «المستخدم المثالي»، استُبعِد هؤلاء عملياً من الانتفاع الكامل من التحوّل الرقميّ، وإن أتيح لهم نظريّاً.
هنا، تلتقي التقنية بالعدالة. فالعدالة في الدولة الذكية ليست في إتاحة الخدمة للجميع على الورق، بل في جعلها قابلةً للاستخدام من الجميع واقعاً. ويتطلّب ذلك أن يتحوّل «مبدأ التصميم الشامل» (Inclusive Design) إلى قاعدةٍ حاكمة لا خياراً فنياً. فيُشترَط —ضمن «البروتوكول العام للحكومة الذكية» وتوابعه الفنية— أن تلتزم الخدمات بمستوياتٍ معياريةٍ للنفاذ الرقمي: وضوح في التباينات، إمكان استخدام قارئات الشاشة، دعمُ تكبير النصوص دون انكسار الواجهة، إمكان التنقّل بلوحة المفاتيح، بدائل لغوية للرسائل المصيرية، وخطواتٍ مختصرة للعمليات المتكرّرة.
لكن العدالة لا تقف عند حدّ تحسين الواجهة؛ بل تقتضي إعادة تعريف دور قنوات الخدمة المساندة. فالمراكز التقليدية لا يجب أن تُلغى أو تُهمّش، بل تُعاد هندستها لتصبح «قنوات مؤازرة» للتحوّل الرقمي: يذهب إليها المستفيد الذي يعجز عن التعامل مع المنصّة، فيجد موظّفاً يستخدم «سهل» نيابةً عنه ضمن ضوابط، لا مساراً ورقيّاً موازياً. وبذلك، يُرفع المستخدم الأضعف إلى المنصّة، ولا يُعاد بناء منظومةٍ بديلةٍ له. في الاجتماع بين التقنية والعدالة، يجب أن تبقى قاعدة الدولة الذكية واضحة: لا يُترَك أحدٌ خلف الشاشة.
حاجز التوقّعات.. حين تُحمَّل المنصّة ما ليس من شأنها
في الجزء الأول من السلسلة، أشرنا إلى تضخّم «حاجز التوقّعات المجتمعية»، وكيف أن الجمهور كثيراً ما يتعامل مع «سهل» كما لو كان نظاماً أمّاً للدولة أو حلاً سحرياً لكلّ التعقيدات المؤسسية. هذه الظاهرة ليست شعوراً عابراً؛ بل هي تحدٍّ استخداميّ مباشر: فالمستخدم الذي يدخل إلى المنصّة متخيّلاً أنه سيتخلّص —من أول يوم— من كلّ إرث البيروقراطية، سيخرج منها غالباً مثقلاً بالخيبة، حتى لو أنجز كثيراً مما لم يكن قادراً على إنجازه سابقاً إلا بطوابير.
إدارة التوقّعات ليست تفصيلاً ثانوياً؛ بل هي جزء من هندسة التجربة. فكما تُهندَس خطوات الخدمة، يجب أن يُهندَس «الوعد» الذي تقدّمه المنصّة للمستخدم: ماذا تستطيع أن تفعل اليوم؟ وما الذي لا تستطيع أن تفعله بعد لأن البنية المؤسسية لم تتهيّأ له؟ وكيف يتغيّر هذا الوعد مع كلّ مرحلةٍ من نضج البنية والبروتوكول والحوكمة؟
الحلّ يبدأ من داخل التطبيق ذاته: صفحاتُ تعريفٍ واضحة قبل الدخول إلى الخدمات، رسائلُ مرافقة للتحديثات توضّح ما الذي تغيّر، ومؤشراتٌ تُبيّن للمستخدم —في كلّ رحلةٍ خدمية— أين تنتهي مسؤولية «سهل» وأين يبدأ دور الجهة. ثم يمتدّ إلى الخطاب العام: حين تُعلن الدولة عن إنجازٍ في «سهل»، تُبيِّن أنه مرحلة في مسار، وأن الانتقال إلى خدمةٍ بلا مستندات، أو بلا حضورٍ شخصي، أو بلا نماذج، مشروطٌ بما سبق أن قرّرناه من سيادة بيانات وبروتوكول وحوكمة.
بهذا، لا تُستخدم المنصّة لإطلاق وعودٍ أكبر من طاقتها، ولا تُحمَّل ما لا تملك أدواته. فالمستخدم الذي يعرف حدود الأداة، يحكم عليها بعدل، ويصبر على نضجها، ويشارك —بوعيه— في تسريع إصلاح ما وراءها.
الحمل الذهنيّ.. حين تنقل الدولة أعباءها إلى شاشة المواطن
التحدّي الاستخداميّ الرابع هو الحمل الذهني الذي يتحمّله المستفيد عند استخدام الخدمات الرقمية. فكثير من النماذج الحالية تنقل إلى شاشة الهاتف تعقيداً كان موزّعاً بين موظّفٍ ونموذجٍ ورقيّ: عشراتُ الحقول، مصطلحاتٌ قانونية، شروطٌ صغيرة في أسفل الصفحة، وخياراتٌ لا يفهم المستخدم أثرها على معاملته. فيتحوّل ما كان الموظّف يفسّره شفهيّاً إلى واجهةٍ صامتة تُلقي العبء كاملاً على المستخدم، دون أن تهيّئه له.
منطق «الحكومة بلا نماذج» الذي طرحناه في المحور البنيوي، وسيادة البيانات التي قرّرناها في المحور الحوكمي، يجب أن ينعكسا مباشرةً على تقليل هذا الحمل الذهني. فإذا كان من حقّ الدولة أن تعيد استخدام ما تملكه من بيانات، فإن من واجبها ألا تُلزم المستخدم بإعادة إدخالها. وإذا كان من حقّها أن تبني نماذجَ حالةٍ واضحة لكل خدمة، فإن من واجبها ألا تُحمِّله فهم كلّ التفاصيل القانونية لكي يُكمِل خطوةً واحدة.
الحلّ هنا هندسيّ وتجريبيّ معاً: (1) هندسيّ، حين تُصمَّم الخدمات وفق مبدأ «أقلّ ما يلزم من المدخلات»: كلّ حقلٍ يُطلب من المستخدم يُراجع أمام سؤالٍ بسيط: هل تملك الدولة هذه المعلومة في مصدرٍ سياديّ؟ فإن كان الجواب نعم، فلا يُطلب منه. و(2) تجريبيّ، حين يُختَبَر كل نموذجٍ وكل رحلةٍ خدمية على عيناتٍ حقيقية من المستخدمين، لا على مكاتب المصمّمين وحدهم؛ فيُقاس الزمن الذي يحتاجه المستفيد ليفهم كلّ خطوة، وتُرصَد نقاط التوقّف، وتُبسَّط اللغة حيث يتعثّر الناس، ويُعاد ترتيب الخطوات حيث تتكرّر الأخطاء.
ولأن هذا العمل لا يمكن أن يُترك لاجتهاد كلّ جهةٍ منفردة، فإن «نظام التجربة الوطني» يجب أن يضع معايير إلزامية للبساطة اللغوية، وحدوداً عليا لعدد الحقول في كل خطوة، وتوصياتٍ لعرض الخيارات بشكلٍ تدريجيّ (Progressive Disclosure) لا يغرق المستخدم بكلّ شيءٍ دفعةً واحدة.
انعدام الثقة.. حين تخون التجربة وعد الدولة الرقمية
لا تزال في ذاكرة المجتمع صورُ الطوابير، وتأجيل المعاملات، و«الموظف المختص» الذي لا يظهر. هذه الذاكرة لا تُمحى بإطلاق تطبيق، بل بمراكمة تجارب ناجحة. وأيّ تجربةٍ رقميةٍ تنتهي بلا نتيجةٍ واضحة، أو بخطأٍ غير مفسّر، أو بمسارٍ ينقطع دون مخرج، تُعيد إلى السطح تلك الذاكرة القديمة، وتُرسِّخ في ذهن المستخدم أن «الرقمنة» ليست سوى غطاءٍ جديدٍ لعجزٍ قديم.
الثقة الاستخدامية لا تُبنى على الشكل، بل على «قابليّة التوقّع». المستخدم يريد أن يعرف: ماذا سيحدث بعد هذه الخطوة؟ ماذا يعني هذا الزرّ؟ ماذا يحدث لو انقطع الاتصال؟ ماذا لو أعدت المحاولة؟ أين يمكن أن أراجع إن تعطّلت الخدمة؟ إن لم تجِب المنصّة عن هذه الأسئلة بوضوح، أصبحت كل تجربةٍ جديدة مغامرة، لا مساراً مطمئناً.
من هنا، يجب أن يتحوّل مبدأ «قابليّة الملاحظة الوطنيّة» الذي قرّرناه في المحور التقني إلى أثرٍ مباشر في الواجهة: (1) فيُعرض للمستخدم —لحظة بلحظة— ما يحدث في خلفية المعاملة، استناداً إلى «الأحداث» التي تبثّها الأنظمة. و(2) تُقدَّم رسائل الخطأ لا كرموزٍ مبهمة، بل كتفسيرٍ مبسّط لما جرى، مع إشارةٍ صريحة إلى الجهة المسؤولة عن المعالجة التالية، والوقت المتوقَّع لذلك إن أمكن. و(3) يُتاح للمستخدم —من داخل التطبيق— تقديم بلاغٍ أو اعتراضٍ يُسجَّل في النظام ذاته الذي تراه «مرآة الأداء الوطنيّة»، فلا تضيع شكواه بين الهوامش. بهذا، تتحوّل كل تجربةٍ استخدام إلى لبنةٍ في بناء الثقة، لا إلى قصّةٍ جديدةٍ تُروى عن تعقيدٍ مستتر وراء شاشةٍ أنيقة.
تعدّد القنوات.. الدولة واحدة ولو تعدّدت الشاشات
التحدّي الاستخداميّ السادس هو التقطيع غير المنظّم لمسارات الخدمة بين قنواتٍ مختلفة: موقعٌ إلكتروني قديم، تطبيق «سهل»، مركز اتصال، زيارةٌ شخصية، وربما تطبيقٌ خاصّ بجهةٍ معيّنة. كثيراً ما يجد المستخدم نفسه يبدأ في قناةٍ وينتهي بأخرى، دون أن تصاحبه الحالة ذاتها؛ فيُعاد ملء البيانات، وتُكرَّر الخطوات، وتضيع على الطريق آثار ما أنجزه.
الدولة الذكية يجب أن تُبنى على مبدأ «القنوات المتعدّدة ذات المنطق الواحد». أي أن يسمح البروتوكول والبنية والحوكمة بأن تُنجَز الخدمة —من حيث المبدأ— عبر أي قناةٍ تُناسب المستفيد، لكن بمنطقٍ واحدٍ للبيانات والحالات؛ فإذا بدأ المعاملة من «سهل» ثم اضطرّ —لسببٍ ما— إلى استكمالها في مركز خدمة، وجد الموظّف أمامه نفس الحالة، ونفس الأحداث، ونفس القيود، لا نسخةً أخرى تبدأ من الصفر.
ولتحقيق ذلك، لا يكفي ربط القنوات تقنياً، بل يجب أن تُفرض على الجهات قاعدةٌ حاكمة: لا تُنشأ خدمةٌ لقناةٍ واحدة، بل تُنشأ أولاً بوصفها «منطقاً وطنياً» للحالات والمراحل، ثم تُطبَّق واجهاتها على القنوات المختلفة وفق خصائص كلّ قناة. وبذلك، تُحافِظ الدولة على وحدة التجربة ولو تعدّدت الشاشات، فلا يشعر المستخدم بأن لكلّ قناة دولةً أخرى خلفها.
من مستخدمٍ متلقٍّ إلى شريكٍ في تصميم التجربة
التحدّي الاستخداميّ الأخير —ولكنه الأبعد أثراً— هو بقاء المستخدم في موقع «المتلقِّي السلبيَّ» لتجربةٍ تُصمَّم له دون مشاركته. فالدولة —مهما بلَغ وعي خبرائها— لا تستطيع أن تحيط بكلّ تفاصيل حياة من تخدمهم؛ ومن ثمّ، فإن الاكتفاء بتصميمٍ مركزيّ للتجربة يحرم المنظومة من أعمق مصادر التحسين: خبرة المستخدمين أنفسهم.
إذا كانت «البيئة البرمجية للبروتوكول» قد فُتِحت لتصبح سوقاً للأدلّة البرمجية بين الجهات، فإن المحور الاستخداميّ يدعو إلى فتح مساحةٍ موازية لتجربة المستخدم؛ مساحةٍ تُدار فيها ملاحظات الناس واقتراحاتهم وتجاربهم على المنصّة، وتُحوَّل فيها الشكاوى المتكرّرة إلى «قصص استخدام» (User Stories) تُعاد على أساسها هندسة الخدمات. ويمكن أن تتجاوز المشاركة حدود الرأي إلى حدود البناء، عبر فتح واجهاتٍ برمجية آمنة تسمح لمبادرات المجتمع —من شركات ناشئةٍ أو فرقٍ أكاديمية— بتقديم أدواتٍ مساندةٍ فوق «سهل» نفسه: أدواتٍ للشرح، أو للمساعدة التفاعلية، أو للموائمة مع احتياجات فئاتٍ بعينها؛ كلّ ذلك ضمن إطار البروتوكول والحَوكمة والسيادة البيانية.
بهذا، يتقدّم المستخدم خطوةً من موقع المتلقّي إلى موقع الشريك؛ فلا تعود التجربة مشروعاً يُفرَض على الناس، بل مساراً يتكوّن معهم وبهم، ويستفيد من ذكائهم الجمعي كما يستفيد من ذكاء الدولة المؤسسيّ.
المحور الاستخداميّ.. حيث تنكشف حقيقة الدولة الذكيّة
يتّضح من هذه القراءة أن المحور الاستخداميّ ليس طبقةَ «تزيين» تُضاف في نهاية الطريق، بل هو المساحة التي تُختبَر فيها كلّ طبقةٍ سبقت: البنية، والبروتوكول، والتقنية، والحوكمة. فغياب سيادة البيانات يتجلّى في نماذج مكرّرة، وضعف البروتوكول يظهر في رسائل متناقضة، وقصور الحوكمة يُرى في استثناءاتٍ يلمسها المستخدم قبل أن يقرأها في تقرير، واختلال التقنية ينعكس في تجربةٍ متقطّعةٍ لا يمكن التنبّؤ بها.
وحين تستقيم هذه الطبقات معاً، يصبح من الممكن أن نجيب في المحور الاستخدامي عن أسئلةٍ بسيطة في ظاهرها، عميقةٍ في أثرها: هل يستطيع أيّ مواطن أو مقيم أن ينجز أهمّ معاملاته دون مساعدةٍ بشريةٍ دائمة؟ هل تتّسق تجربة المستخدم، مهما انتقل بين الجهات والقنوات؟ هل يشعر أن الدولة تعرفه حقّاً بما لديها عنه من بيانات، فلا تُثقله بما تعرفه سلفاً؟ هل يستطيع أن يفهم —ببساطة— ماذا يحدث لمعاملته، ومتى، ومن المسؤول عنها؟ وهل يطمئن إلى أن كلّ دقيقةٍ يقضيها على المنصّة أقلّ من دقيقةٍ كان سيقضيها في طابورٍ بالأمس؟ هذه الأسئلة، في نهاية المطاف، ليست أسئلة واجهات، بل أسئلة دولة: أيّ صورةٍ تريد أن تُقدّمها لنفسها في عين من تخدمهم؟ هل تريد أن تظلّ جهازاً ثقيلاً يُرى من وراء مكاتب، أم تصبح «خدمةً عادلةً بيّنة» تُمسَك في كفّ اليد؟
في الجزء السادس والأخير من هذه السلسلة، سنغادر فضاء التفاصيل إلى فضاء «المحور المفهوميّ»؛ حيث لا نسأل عن كيف تُبنى المنصّة أو كيف تُدار، بل عن أيّ دولةٍ نريد أن نبني بهذه الأدوات: ما صورة المواطن، وما معنى الخدمة العامة، وما موقع الإنسان من دولةٍ تستند إلى البيانات والأتمتة. فهناك تُحسَم وجهة المسار: هل تكون الرقمنة أداةً لاستكمال إنسانيّة الدولة، أم وسيلةً لتغليب الآلة على الإنسان؟
فاللّهم أبرِم لهذه الأمّة أمرًا رشدًا..
الجزء التالي •
«سهل» والأتمتة الكبرى: سادساً — المحور الختامي: التحدّيات المفهوميّة